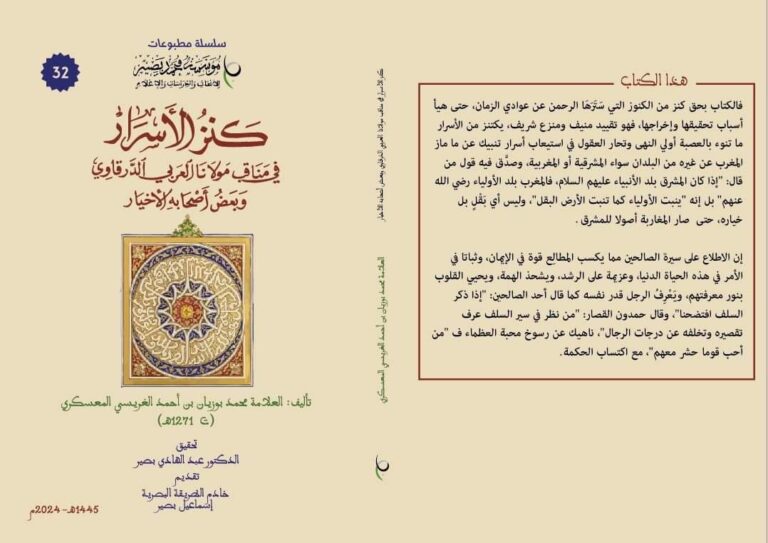الحرابة في ثوبها الجديد

الحمد لله، الحمد لله الخالق البارئ المصور، العزيز الجبار المتكبر، العلي الذي لا يضعه عن مجده واضع، الجبار الذي كل جبار له ذليل خاضع،
وكل متكبر في جناب عزه مسكين متواضع، فهو القهار الذي لا يدفعه عن مراده دافع، الغني الذي ليس له شريك ولا منازع، القادر الذي بهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه، وقهر العرش المجيد استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه،
ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد لا شريك له شهادة تنيلنا رؤيته، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أنزل عليه النور المنتشر ضياؤه حتى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجاؤه، اللهم صل عليه صلاة تخرجنا بها من الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأثني بالسلام عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين ونحن معهم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون:
قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية، فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرنيين وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد”، فقال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)، وفي الآية استعارة ومجاز، إذ الله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد، والمعنى: يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لإذايتهم، ولزيادة التشنيع عليهم، ولبيان أن كل من يهدد أمن المسلمين ويعتدي عليهم يكون محارباً لله ولرسوله ومستحقاً لغضبه سبحانه وعقوبته.
والمحاربة: هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر.
واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة، فقال مالك: “المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة {هاجت هائجة} ولا ذحل {الثأر} ولا عداوة”.
واختلفوا في حكم المحارب قال أبو ثور: “الإمام مخير على ظاهر الآية، ومعنى التخيير عند مالك: “أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع لا يدفع ضرره، وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قَطَعَهُ من خلاف، وإن كان ليس له شيء من هاتين الصفتين أُخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير” فقال تعالى: (أو ينفوا من الأرض).
واختلف في معنى النفي، قال مالك والكوفيون: “نفيهم سجنهم” فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها، فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض إلا من موضع استقراره، واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك:
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا
وحكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون وقال: “أحبسه حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيه”، والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض النازلة، وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه، وإن كان غير مخوف الجانب فظن أنه لا يعود إلى جناية سرح، قال ابن عطية: “وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب ويسجن حيث يغرب، وهذا على الأغلب في أنه مخوف”، ووجب على المسلمين التعاون مع السلطان على محاربتهم وقتالهم وكفهم عن أذى المسلمين، ردعا لهم عن سوء فعلهم لشناعة المحاربة وعظم ضررها.
ولم يقف الأمر عند ذلك بل وعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، قال تعالى: (لهم في الدنيا خزي) وقد رتب الله العزيز الحكيم لفعلهم ذلك جزاء وفاقا فقال: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم).
أيها الإخوة المؤمنون:
إن أمن الجماعة المسلمة وصيانة النظام العام الذي تستمتع في ظله بالأمان، وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة، كله ضروري كأمن الأفراد بل أشد ضرورة؛ لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به، فضلاً على صيانة هذا النموذج الفاضل من المجتمعات، وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار، كيما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير، وحتى تترقى الحياة الإنسانية في ظله وتثمر، وتتفتح في جوه براعم الخير والفضيلة والإنتاج والنماء، وبخاصة أن هذا المجتمع يوفر للناس جميعاً ضمانات الحياة كلها، وينشر من حولهم جواً تنمو فيه بذور الخير وتذوب بذور الشر، ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج، ثم يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية، ولا يدع دافعاً ولا عذراً للنفس السوية أن تميل إلى الشر وإلى الاعتداء، فالذي يهدد أمنه – بعد ذلك كله – هو عنصر خبيث يجب استئصاله؛ ما لم يثب إلى الرشد والصواب..
فالآن يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث، وهو المعروف في الشريعة الإسلامية بحد الحرابة ونحن نختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه، وهي أن العقوبة قد توقع على مجرد الخروج وإخافة السبيل، لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولاً منع وقوع الجريمة، والتغليظ على المفسدين في الأرض الذين يروعون دار الإسلام، ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله في هذه الدار، وهي أجدر جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام.
والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده، إنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلاّ السيف، فكما قال سيدنا عمر أو سيدنا عثمان رضي الله عنهما: “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن، ونهي القرآن، بل يقدم على المحارم ولا يبالي، لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان، ارتدع، خاف من العقوبة السلطانية.
أيها الإخوة المؤمنون:
إن موضوعنا اليوم يدور حول ظاهرة اجتماعية قديمة جديدة، قديمة في أصلها وتسميتها، جديدة في وسائلها وأساليبها وتسميتها، ففي سالف الأزمان كانت تسمى بالحرابة واليوم اصطلح عليها بالتشرميلة، احترفها شرذمة من صبيان مجتمعنا هم في الأول والآخر يبقوا أبناؤنا وإخواننا وإن بغوا علينا، استهوتهم شياطين الجن والإنس، سحروا أعينهم وصوروا لهم الرجولة بمفهومها السلبي، رجولة فقدت مقوماتها من أول وهلة وهما القوة والأمانة، ومن جمع في سلوكه وخلقه بين القوة والأمانة، كان أهلا لكل خير، ومحلا لثقة الناس به على أموالهم وأعراضهم، لكن يا أسفا على شبابنا الذين أخذتهم العزة بالإثم فأضحوا يستعرضون عضلاتهم الخاوية على الهواء ويتبجحون بسلب إخوانهم وأخواتهم أتفه ما يملكون بل الأدهى والأمر أنهم حالوا بينهم وبين عبادتهم وطلب معاشهم ونسوا بأن من نِعَم الله تعالى على خَلْقه نعمةَ الأمن، بها يَنْعَمون بالسكينة والاستقرار في أنفسهم وذويهم وأموالهم، ونحو ذلك، ولهذا امْتَنَّ الله تعالى على أهل مكة بأن جعل حَرَمَهم آمنًا، يأمنون فيه من الإغارة أو النهب أو القتل أو السلب أو غيرها، مما لا يأمن منها غيرهم، فقال الحق سبحانه: (أوَ لمْ يَرَوْا أنَّا جَعَلْنا حَرَمًا آمِنًا ويُتَخَطَّفُ الناسُ من حولِهم) صدق الله العظيم. (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون).
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له، عباد الله من اتقى الله فقد فاز برضى مولاه ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فأجره على الله.
أما بعد أيها الناس: لقد ذكرنا في الخطبة الأولى أن ظاهرة التشرميل هي امتداد لظاهرة الحرابة ولكن في ثوب جديد.
لقد جعل الإسلام الأمن جزاءَ مَن آمَن وعمل صالحًا، فقال تعالى: (الذين آمنوا ولم يَلْبِسوا إيمانَهم بظُلْمٍ أولئك لهم الأمنُ وهم مُهْتَدون).
وإذا كان الأمن بهذه المثابة، فإن الله سبحانه قد حَرَّم ترويع المسلم وإخافتَه، سواء كان هذا الترويع بالقول أو بالفعل، وسواء كان على سبيل الجد أو اللعب.
روى أبو داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: “حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا”.
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَن نظر إلى مسلم نظرةً يُخيفه فيها بغير حق أخافَه الله يوم القيامة”.
ويؤكد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن ترويع المسلم ظُلْم عظيم، يستَوْجِب إخافة فاعله يوم القيامة، وعدم تأمينه من أفزاع هذا اليوم الكثيرة ولهذا فقد رُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “مَن أخافَ مؤمنًا كان حقًّا على الله أن لا يُؤَمِّنَه من أفزاع يوم القيامة”.
ورُوِيَ وعن عامر بن ربيعة؛ أن رجلا أخذ نعلي رجل فغيبها وهو يمزح، فذكر ذلك للنبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: “لا تُرَوِّعُوا المسلم، فإن رَوْعَة المسلم ظلم عظيم”.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح وقال: “من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه” رواه مسلم.
قال الإمام القرطبى رحمه الله: “لعن النبى صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقا، جاداً كان أو هازلاً، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلاً فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين”.
وإذا كان مجرد ترويع الآمنين مُحَرَّمًا، ولو بمجرد النظرة المخيفة، فإن هذا يدل على أن ترويعَه بالأصوات المُنكرة، أو انتهاك حُرْمته، أو الاعتداء على نفسه، أو على عضو من أعضائه، أو على ذي قرابة منه، أو على ماله، أو عمله أشد حُرْمَة وإثمًا، وأن فاعله يستحق اللعن والوعيد الشديد الوارد في الأحاديث السابقة، لعِظَم جُرْمه وظُلْمه، فكيف بمن قطعوا طرق إخوانهم صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، وأرعبوهم، وأخافوهم، وهددوا أمنهم وسكينتهم، واعتدوا عليهم بغير جريرة ارتكبوها، وأقضوا مضاجعهم، وأساءوا إليهم أبلغ إساءة في أنفسهم وأموالهم وأهليهم ومساكنهم، ولم يسلم من ضررهم أحد في غدوه ورواحه؟ فإن إثمهم يتعاظم بقدر ما اقترفوا من ذنوب ومظالم، لن يغفرها لهم من ظلموا منهم، سواء بقى المظلوم حيا أو فارق الحياة.
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم من عذابه المهين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.